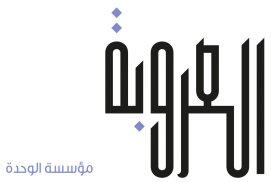عام 2001 اتّصل بي مسؤول في وزارة الثقافة، وأبلغني أنّني سأكون عضواً في وفد باسم الوزارة سيذهب إلى الإمارات المتّحدة، ومنه علمت أنّ الصديق الشاعر محمود نقشو مدعوّ من حمص، ولا أكتمكم أنّني سُررت بقدر ما استغربت، فمثل هذه الدّعوات، عادة، تكون من نصيب الأدباء المقرّبين من سكّان العاصمة، فأنا لم أزر هذه البقعة من قبل، ولا أعرف عنها إلاّ ما قرأته في الصحف.
كان الوفد كبيرا ويضمّ فرقة للفولكلور، نسيت اسمها، ولها شُهرتها، ومصوّرين ضوئيّين، وكان برئاسة وزيرة الثقافة آنذاك الدكتورة مها قنّوت، وهي شاعرة، وكان بيننا عدد من الأدباء السوريّين الذين أُتيح لي أن أعرفهم عن قرب، والسفَر كما يقولون كشّاف رائع، فهو يتيح لك أن تعرف بعض ما وراء التصرّفات، أو الملامح، أو طريقة العرْض أو الابتسام، ولا كاشف كالسفَر.
وصلنا “ الشارقة بعد منتصف الليل، واستقبلتْنا في المطار موظّفة خليجية، وأُركْبْنا سرافيس تنقلنا إلى أبو ظبي، الأوتوسترادات مضاءة حتى كأنّ الدنيا نهار، والسائق يقف عند كلّ شارة حمراء رغم أنْ لا أحد على الطريق،في أبو ظبي بقينا قرابة عشرة أيام، ربّما تقلّ، والعتب على الذاكرة التي كثيرا ما تخذلني، وسأُجمل ماقرّ في داخلي عن تلك السّفرة.
-دار الثقافة في أبو ظبي بناء مؤلّف من عدّة طبقات، ومزوّد بأحدث وسائل التكنولوجيا، ومضاء بطريقة فنيّة مدروسة، وفيه صالات لعرض لوحات الفنّ التشكيلي، وقاعة لعرض الأفلام السينمائيّة، وأبّهة البذخ واضحة، ولماذا يقلّل وضع الأدام على طعامه من كان ذا يُسْر،؟!!
-الذين يحضرون الأمسيات الشعريّة قسم كبير منهم من العرب العاملين في أبو ظبي، ربّما جاؤوا ليتنسّموا شيئا من هواء الوطن في زُرقة ما يفتحه الشعر من آفاق السِّحر.
-الغالب على النّاس الذين يملؤون الشوارع، والمولات، والذين يقودون سيارات الأجرة،.. الغالب عليهم أنّهم ليسوا عربا، بل هم إمّا باكستانيّون، أو هنود، أو ماليزيّون، أو إيرانيّون، وعليك من أجل التفاهم مع السائق للذهاب إلى مكان ما أن تتكلّم الإنكليزيّة، فيا للمفارقة، بلد عربيّ اللسان والانتماء، ولغة الحوار اليوميّ فيه الإنكليزيّة،!! وهذا الواقع هو الذي أعاد إلى ذاكرتي ما كتبه كتّاب عروبيّون عن الخطر الذي يتهدّد عروبة الخليج، وعدد السكّان الأصليّين قليل جدا بالنسبة لعدد الوافدين إلى هذه الإمارة، وتلك مُفارقة أخرى.
-المولات التجاريّة واسعة جداً، وتضمّ عدّة طوابق، ومزوّدة بأدراج كهربائيّة، وتجد فيها من الإبرة حتى السيارة، وذات أجهزة حديثة، من كاميرات المراقبة، حتى الآلات الحاسبة.
-اللافت تلك المباني الشاهقة المصنوعة بهندسة ناطحات السّحاب، والمدهش أنّها ذات نوافذ عريضة في بلاد حارّة، وهذا ما يوجب أن تكون النوافذ مزدوجة البلّور للتخفيف من أثر الحرّ، ولا يمكن الجلوس فيها دون مكيّفات، ولو أنّها بُنيت بأسلوب العمارة العربيّة الإسلامية، التي تعتمد على النوافذ الطولانيّة المتعدّدة، لخفّفت الكثير من النفقات، ولكنْ .. أنّى ذلك وهي نسخة عن ناطحات السحاب في أوروبا وأمريكا؟!!
فجأة وأنا أتأمّل هذه الأبراج العالية تخيّلتُ أنّ هذه المدن كانت قائمة في باطن الأرض، وأنّها صعدت إلى الأعلى بكبسة زرّ، وحضرتْ في المقابل رواية عبد الرحمن منيف “ مدن الملح”، فهي رغم ارتفاعها، وما تتمتّع به من تسليح قابلة لأنّ تذوب كالملح في لحظة ما.
-في أحد المقاطع شاهدتُ تربة حمراء توحي بالخصوبة، وقد زُرعت فيها الأشجار الخضراء، الموجودة في معظم مساحات المدن، وبالقرب منها تُربة صفراء صحراويّة، ورغم ألفة الخضرة، وجمالها كان شيء ما أيضا يبدو أنّه مُصنَّع بطريقة تلك الناطحات الغريبة الهويّة المعماريّة.
-سألت :” أما بقي شيء من آثار هذه البلاد القديمة التي اعتمدت على مواد البيئة لأنّي أرى فيها من الحنان ما لا أجده في غيرها”؟!! فقيل لي :” بلى، ثمّة قرية تراثيّة تحفظ كلّ تلك المعالم، اهتمّت ببنائها الدولة”، لقد سمعنا عنها ولم نرها…
عبد الكريم النّاعم