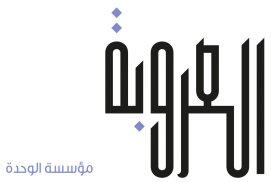ولدي الغالي، فلذة كبدي..!
أتذكر يا صغيري، «وقد صرتَ اليوم شاباً قدّ الدّنيا» ، تلكَ الليلة المشؤومة، حين ارتفعت حرارتك، فوصلت لِقوس الأربعين، أو أقلّ بقليل؟! أتذكر يا حبيبي، كيف تحوّلَ بيتنا المُستأجَر يومها، إلى «مستشفى صغير»، دبّت فيه الحركة والنّشاط دفعة واحدة؟ وكيف صارت أمّك الحنون ممرّضة ناجحة؛ إنْ لم أقلْ «طبيبة ممتازة»؟ أعطتك أوّلاً حبّتي «إسبرين» للأطفال، كخافض للحرارة الملعونة، التي غَزَتْ جسدك فجأة، فهذا إسعافٌ أوَليٌّ، تعرفه كلُّ أمّ! أحضرَتْ قطعة قماش نظيفة، ووِعاءَ نظيفاً فيه ماءٌ بارد، بلّلت القطعة، عَصَرَتْها، فرَشَتْها على جبينك الأغرّ، لامتصاص شيءٍ من تلك الحرارة الغازِية..عاودَتْ هذا الفعل مرّات، حصل ذلك بِلَيلةٍ شتويّةٍ، بالغة البرودة، باهظة الصّقيع، وقتها، لم يتطرّق لِنشاطها أيُّ ملل، لم يبدُ على مُحيَّاها السّمح أيُّ أثرٍ للتأفّف أو الضّجر! أوتذكر، كم مرّة استخدمت أمّك الغالية «ميزان الحرارة»، لمعرفة ارتفاع درجتها، أو انخفاضها؟ كان هبوطها، ولو قليلاً، كافياً لإحياءِ قبسٍ من الفرح، باثّاً الطمأنينة في قلب كلٍّ من الأبوين!! أتذكر يا ولدي، كيف كانت أمّك، طيّبة القلب، حريصة على التقليل من الحركة والضّوضاء، مُطالِبة إيّايَ بإطفاء مصباح الغرفة الكهربائي، على أنْ أتركَ مصباح الرّدْهة القريبة، يسعلُ ببعض الضّوء، علَّ قليلاً من النّعاس يصافحُ عينيك الذابلَتين، فتركن للنّوم بسكينة وهدوء، عندها تهنأ النفوس، تطمئنّ القلوب! بتلك الليلة الرّصاصيّة، نامت الكائنات جميعاً، ما عدا صوتَ ديكٍ طاعِنٍ لجارٍ قريب، كان يئنّ، كأنّه يعاني ارتفاعاً مماثلاً بالحرارة.. نعم يا بُنيّ، المستيقظون: (أنتَ..السُّخُونة المُعادِية..أمّك..أنا.. الدّيك الطاعِن.. المصباح الكهربائي، الذي يرشحُ منه إلى فضاء غرفتك بعضُ الضوء الباهِت.. والقلقُ الذي سكن قلبي وقلب أمّكَ بآن)! بتلك الليلة الصّعبة، همست أمّك بأذني: (يا رؤوف، حرارتُه تقلقني، أنا أخاف جدّاً من ارتفاع الحرارة عند الأطفال، ألم تسمع بالطفل، «سليم»، ابن جيراننا، كيف اختطفت الحرارة المرتفعة طفولته الريّانة، فارتحل بِلَيْلةٍ ليْلاء؟! أكنتَ تسمعني يا ولدي، وأنا أقول لأمّك القلقة: اصبري يا «رحيمة» حتى الصباح، من أين آتي لولدنا بطبيبٍ، بهذه الليلة القارسِة المَطِيرة؟ أرجوكِ اصبري، وكّلي أمرَه لله، «الصّباح رَبَاح»! كنتُ مثلها يا بنيّ قلقاً جدّاً عليك، كنت أداري قلقي وألمي، حتى لا أضيف لمعاناة أمّك قلقاً إضافياً، أو حزناً آخر.. لكنّها، بعاطفة الأمومة العميقة، كانت تقرأ بِتضاريس وجهي معجم الأسَى، الذي كان قد خطّ أبجديّته فوق مواجع قلبي، ودفقات عاطفتي!! وقتها ردّدتُ بِسِرّي، بلغة «المونولوج»، «المالُ والبَنُونَ زِينةُ الحياةِ الدّنيا..»! فإذا نَهشَ المرض أحد الأناسِيِّ، كان المالُ أحياناً طوقَ النّجاة، بعد عناية ربّ السماوات والأرَضِين! «الولد غالٍ، البنت غالية»، جملتان اسميّتان خبريّتان، نطقهما لساني، أو نطقتْهما أمّك وحدَها، أم نطقهما قلبانا معاً، ونحن بِبوتقة هذا الموقف العصِيب، الذي لا نُحسَد عليه البتّة!! الحقَّ، حصل هذا مرّاتٍ غَفِيرات.. ولدي، فلذة كبدي، «سِنان»، أستغربُ منْ حرارة مجنونة، غَزَتْ جسدك الطفوليّ الطاهر، وسنُّك لم تقفز حاجز السّنتين بعدُ، وأستهجنُ اعتداءً حراريّاً كهذا، لا يخجل منْ براءة الأطفال، ونقاوَة قلوبهم!! صغيري، بتلك الليلة الخالية من الفرح، الضاجّة بالمواجع والاحتمالات – لنا نحن الثلاثة – كنتُ أقرأ بِعينيّ أمّك سِفْرَ العطف الأمُومي كاملاً، بينما يداها الحانيتان، تقدّمان لك الكمّادات المائيّة، عسَى أنْ تنخفض تلك الحرارة الغازِية! ولدي..كبدي..صنو روحي، كم تمنّينا معاً – أمّك وأنا – أنْ يكون أحدُنا، هو المُصاب نيابة عنك، أو هو الطريح بالفراش لا أنتَ، لتنامَ قريرَ العين، هانىءَ الحال، بتلك الليلة!
* * *
حين أرسلت الشمسُ عصافيرَ أشعّتها، وقبل التوجّه لأقرب طبيب للأطفال، لمعاينة الصغير، هبطت حرارته، عُرِف ذلك بميزان الحرارة، لحظتئذٍ قالت الأمّ «رحيمة» بفرح طاغٍ، مخاطبة زوجها:
الحمد لله، تعال انظر يا «أبا سِنان»، انخفضت حرارته، صارت طبيعيّة! يا لهناءة روحي، وسعادة قلبي!
مُعَقّباً قالَ الأب:
لنحمد الله؛ جَلَّ في عُلاه، لقد زالَ الخطر..
* * *
لدى الأبوَين: تهيّجت أنْبَاضُ فرحٍ غامر، تأخذ طريقها، من القلب إلى العينين، اللتين كانتا لدى كلّ منهما، طوال الليلة المنصرمة، ذابلتين كَلِيلتَين..الآن استفاق، على حين غرّة، سرورٌ غائبٌ، كان غافِياً…
وجيه حسن